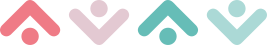ليس من السهل معرفة الأعداد الدقيقة للّاجئين لأسبابٍ عدّة أبرزها: غياب الوكالات الإعلاميّة الحرّة في مناطق النزاعات والتدفّق اليومي للنازحين واللاجئين.
من أين يبدأ الحديث عن أطفال السودان؟ لقد أدّت الصراعات الطويلة الأمد والعدد في البلاد إلى مقتل ما لا يقلّ عن ثلاثة ملايين طفل، والعدد قد يكون أعلى منذ ذلك بكثير. لا أحد يعرف على وجه الدقّة العدد الفعليّ للضحايا من أطفالنا، والسبب؟ الغياب الكبير لوسائل الإعلام بأشكالها المختلفة عن تغطية مأساة أطفال السودان ومعاناتهم على مدى سنواتٍ طويلة.
كما أجبرت الحربُ الملايين في السودان، وبينهم ملايين الأطفال، على خيارَين لا ثالثَ لهما: إمّا النزوح داخليًّا نحو المدن الكبرى والولايات المجاورة التي تشهد استقرارًا نسبيًّا، أو الفرار إلى دول الجوار السوداني بصفتهم لاجئين. في إحصائيّاتٍ ترجع إلى العام 2003، بلغ عدد النازحين داخليًّا 5 ملايين نسمة، واللاجئين إلى دول الجوار 8 ملايين. وقد قُدّر عدد الأطفال بينهم أكثر من ثلاثة ملايين.
مع اندلاع الحرب في 15 نيسان/ أبريل 2023، ارتفعت هذه الأعداد بشكلٍ كبير. ليس من السهل معرفة الأعداد الدقيقة للّاجئين لأسبابٍ عدّة أبرزها:
ومع ذلك، تشير إحصائيّات منظّمات دوليّة معنيّة بمتابعة الشؤون الإنسانيّة وشؤون النازحين واللاجئين إلى أنّ الحصيلة الإجماليّة للنازحين واللاجئين داخل السودان وخارجه بلغت حتّى تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023 أكثر من 11 مليونًا. أمّا عددُ النازحين داخليًّا فيبلغ حاليًّا أكثرَ من 8 ملايين، بحسب «المنظمة الدوليّة للهجرة» و«مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» OCHA. ومع ذلك، إنّ اعتمادنا على وسائل الاتّصال من المواقع نفسها جعلنا على درايةٍ بما يحصل على أرض الواقع بطريقةٍ أكثر دقّة. انطلاقًا من هنا، ترفع إحصائيّاتٌ أخرى أعدادَ الفارّين من السودان نحو الدول المجاورة إلى 20 مليون لاجئ، بينهم 8 ملايين طفل، بينما تتحدّث «اليونيسف» عن 12.5 مليون طفل نزحوا حديثًا. وتوصف هذه الأزمة بأكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم. يُضاف إليهم المقتولون والجرحى والمفقودون والمختطفون، والذين يُقدَّر عددهم بحوالي مليونَين و200 ألف طفل.
على أرض الواقع، لم تتوقّف عمليّة النزوح واللّجوء حتى تاريخه، فالآلاف ما زالوا يفرّون إلى دولٍ مجاورة. وتُعتبر دارفور أكثر الولايات تأثّرًا بالحروب بسبب حدودها المفتوحة مع كثيرٍ من الدول. وقد أصبحت نقطةَ عبورٍ إلى دول الجوار مثل ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى والكاميرون وجنوب السودان.
وكما هو معروف، الأطفال هم الأكثر عرضةً لأصعب الظروف وصولاً إلى الموت، فإلى جانب القتل المباشر، يتأثّر الأطفال بشكل كبير بغياب الرعاية الصحية ويصابون بمختلف الأمراض الجسديّة والنفسيّة والعقليّة. وعلى رأس الأمراض الكوليرا التي تفشّت بشكلٍ هائلٍ وتتوسّع يومًا بعد يوم. وحتى تاريخه، تأثّر الآلاف بالمرض، ولقي المئات حتفهم، من بينهم أطفال.
وحول أوضاع الأطفال في دارفور كذلك، كان ممثّل «اليونيسف» في السودان قد أشار مطلع تشرين الأوّل/ أكتوبر الحاليّ إلى أنّ «القتال الشرس والمكثّف في دارفور يؤثّر في كلّ ركنٍ من أركان دارفور، وكلّ ركن من أركان البلاد»، مشيرًا إلى أنه منذ «نيسان/ أبريل، قُتل ما لا يقلّ عن 150 طفلاً هناك وأصيب العديد»، مضيفًا «لا يوجد في دارفور أيّ ركن أمان بالنسبة للأطفال».
أمّا الفاشر، باعتبارها عاصمة ولاية دارفور الكبرى، فقد حضنت حوالي مليون شخص إضافي في حرب 2003، وبلغ عدد سكانها حينها 4,5 مليون نسمة. وعند اندلاع حرب 2023، انتقل معظم سكّان الولاية إلى الفاشر، خصوصًا عندما تمّ الاعتداء على الجنينة وكتم وزالنجي ونيالا. على إثرها، ارتفع عدد سكّان الفاشر إلى 7 ملايين نسمة، من بينهم 3 ملايين طفل. لكنّ المدينة ما لبثت أن تحوّلت إلى ميدان اقتتال وقد تعرّضت إلى 42 هجومًا بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2023.
وأدّى القصف المتواصل على الأحياء السكنيّة إلى مقتل عدد مَهول من سكّانها، خصوصًا الأطفال منهم. ولم تسلَم المؤسسات الحكوميّة والشركات والمصانع والمتاجر والمشاريع الخاصّة من القصف والدمار. على إثر ذلك، فرّ أغلب سكّان الفاشر إلى تشاد على الرغم من وعورة الطرق. وبعد أن تكبّدوا كلّ هذه الصعاب، وصلوا إلى البلد المنشود. حاليًّا، لم يعد هناك في الفاشر أكثر من مليونَي نسمة أغلبهم من العجزة وكبار السنّ، بحسب شهود عيان، بينما تقدّر الأمم المتّحدة عدد سكّانها بـ1.5 مليون نسمة. أمّا تشاد فقد امتلأت باللّاجئين بما يفوق قدرة البلاد والمنظّمات نفسها على استيعابه والتعامل معه.
وبسبب موقع الفاشر الجغرافيّ، لم يكن من الممكن تقديم المساعدات الإنسانية من أيّ اتّجاهٍ كان، وذلك بفعل الانتشار المكثّف للأطراف المتنازعة. وفي أغلب الأحيان تتعرّض القوافل الغذائيّة إلى اعتداءات متكرّرة من الأطراف كافّةً بغرض تقديم الدعم الغذائيّ لمقاتليها. وعلى الرغم من جهود المنظّمات لإنقاذ المتضرّرين في الفاشر، تتعقّد الأمور يومًا بعد يوم بما يأخذ البلاد نحو المجهول.
لعقود، ظلّ السودان يعاني من تدهورٍ في القطاع التعليميّ. ويرجع ذلك إلى أسبابٍ عدّة منها:
كلّ هذه الأسباب وغيرها أدّت إلى تراجع المستوى التعليميّ. ومع ارتفاع تكاليف الدراسة، لم تعد الأسر ذات الدخل المحدود قادرةً على دفع الرسوم المدرسيّة فأصبح الشارع السودانيّ يشهد ارتفاعًا خياليًّا في عدد الأطفال المتسرّبين من الدراسة. وتنتشر عمالة الأطفال بشكل كبير في الأعمال الشاقّة خصوصًا.
وبين هذا وذاك، أتت الحرب لتشكّل عاملاً إضافيًّا يمنع الأطفال من تحصيل حقّهم في التعليم. وتحوّل الطفل السوداني إلى لاجئٍ خارج وطنه أو نازحًا داخلَه مكتوف الأيدي. وبعدما امتلأت المدارس والأماكن العامّة بالنازحين لم يعد هناك في الأصل مدرسة تستقبل الأطفال بهدف تعليمهم، بل لإيواء الناس.
تُدلّل مؤشّرات ما يشهده السودان اليوم على وجود فجوةٍ كبيرةٍ بين صفوف الأطفال، أي قد نكون فقدنا جيلاً بأكمله وأفرادًا وأسرًا. والأخطر، اتّساع الأمّيّة بشكلٍ مضطرد في المجتمع السودانيّ ما يشكّل ضررًا بالغًا على مدى السنين المقبلة. يقع هذا الضرر على الأطفال بصورةٍ خاصّةٍ، وعلى المجتمع بصورةٍ عامّة، ذلك أنّ ضياع تعليم الأطفال يعني ضياع مستقبلهم، وتاليًا حصول انهيارٍ في البنى المجتمعيّة. وفي ظلّ غياب الموسّسات الحكوميّة لا وجود لمن يخطّط. والكلُّ يسأل: أين المدارس؟ والجامعات؟ والمعاهد؟ والمصانع؟ والمنازل؟ والممتلكات؟ والإجابة موجِعة: كلُّها حُطّمت وأُحرقت ونُهبت. ويصحّ القول إنّ البلاد تحوّلت خرابًا وأطلالاً.
انطلق العام الدراسيّ في ولاية البحر الأحمر منتصف أيلول/ سبتمبر التي تُعتبر آمنةً على الرغم من اندلاع اشتباكاتٍ مسلّحة نادرة في مدينة بورتسودان الساحليّة فيها خلال الفترة نفسها. وأتى ذلك بدعمٍ من جهاتٍ محلّية عملت خلال الفترة الماضية على تسريع انطلاق العجلة التعليميّة كي لا يضيع المستقبل التعليميّ لأطفال السودان جميعهم. وبينما الوضع كذلك، يوجد حاليًّا أكثر من 19 مليون طفل خارج المدرسة، منهم 12.5 مليون نزحوا حديثًا، وفق بيانات «اليونيسف». وتحذّر الأخيرة من أنه من دون اتّخاذ إجراءات فوريّة، قد تصل خسائر التعلّم والقدرة على الكسب لهذا الجيل إلى 26 مليار دولار سنويًّا.
يبدو الوضع أفضل قليلاً في معسكرات اللّجوء حيث يقدّم بعضُ المنظمات فرصًا لتعيين المعلّمين/ات وتدريبهم بهدف ضمان استمراريّة التعليم. غير أنّ ذلك لم يكن بالشكل المطلوب بسبب قلّة الإمكانيّات، بالإضافة إلى صعوبة تقديم الداعمين المساعدات الإنسانيّة لجميع المتضرّرين حول العالم بفعل انتشار دوائر الصراع في مختلف الدول والكوارث الطبيعيّة المتزايدة.
كي يتحسّن الوضع في السودان وينعمَ أهله بشيءٍ من الأمان، تحتاج البلاد إلى بعض الوقت والتريّث، ممّا سيسمح بانسياب المساعدات نحو الداخل. يصعب على مطلق منظّمة مزاولةُ عملها في بلدٍ يغيب فيه الأمن بشكلٍ تامّ. انطلاقًا من هذا الواقع، كان من الطبيعيّ مثلاً أن تعلّق منظّمة «أطبّاء بلا حدود» عملها في «المستشفى التركي» حفاظًا على أرواح موظّفيها. كان بإمكان المنظّمة الحصول أقلّه على الحماية من الأطراف المتصارعة، لكنّ الأمر تجاوز حدودَ الصبر. وهذا يدلّل على أنّ هناك طرفًا يفتقر قدرةَ السيطرة على قوّاته، فنراها تعبث كما تشاء متغاضيةً عن حقيقة أنّ الفائدة من الخدمات الطبية ليست محصورةً بأفرادٍ دون آخرين.
لقد كان الأطفال المتضرّرَ الأكبر وبشكلٍ مباشر من ذاك القرار، فاقدين على إثره جميعَ أنواع الرعاية الصحيّة. أمّا المرتبة الثانية لناحية الضرر فاحتلّتها النساء. وأدّى هذا الأمر المؤسف إلى فقدان أرواح كثيرة بين الأطفال والنساء، وبينهنّ حوامل ومرضعات، وكذلك كبار/ات السنّ. لقد تحوّلت حياة هؤلاء إلى كارثة إنسانيّة قلّ نظيرها في عصرنا الحاضر. أمّا حياة الأطبّاء الذين أصرّوا على مواصلة تضحياتهم فكانت تُحصد وسط المعارك. وكان بينهم من يتعرّض إلى الاعتقال والإخفاء القسريّ، ومنها لأغراض الحصول على فدية.
وكانت هنالك أيضًا منظّمات محليّة تعمل في مجال رعاية الطفولة. وبسبب تردّي الأوضاع الأمنيّة، حاولت حصرَ أعمالها في المناطق غير المتأثرة بالحرب. لكن مع توسّع دائرة الاقتتال، والتي شملت أجزاءً واسعةً من السودان، أُجبرت المنظمات على تعليق أعمالها لأنها باتت عرضةً للقتل والنهب والابتزاز والاعتداءت المتكرّرة. وبذلك فقد الأطفالُ الرعاية المطلوبة والدعمَ المعنوي والنفسي والاجتماعي. وقد تحوّلت مستشفيات الأطفال هدفًا للأطراف المتحاربة تحت ادّعاء اختباء عناصر تابعة لأحد الطرفين فيها من أجل حماية أنفسها باعتبارها ملجأَ، أو الاستيلاء على الأدوية المتوفّرة فيها.
في ظلّ هذه الأوضاع المعقّدة التركيب والغياب التامّ للدور الحكوميّ، أصبح من السهل نشوب صراعاتٍ عرقيّة لأبسط الأسباب. من هذه الخلفيّة يأتي الاقتتال القبَليّ. لقد شجّع الاستيلاءُ على الغنائم وسرقةُ الأموال الكثيرَ من القبائل على الدخول في حروبٍ عبثيّة مع قبائلَ أخرى. وقد خلّف هذا أعدادًا كبيرةً من الضحايا معظمُهم من الأطفال الصغار الأبرياء الذين قد تكون حصيلتُهم ثلاثةَ أضعاف الأعداد المعلَن عنها في ظلّ وجود خمسة أطفال بالحدّ الأدنى داخل كلّ أسرة. وكي تزداد الأمور بشاعةً، غالبًا ما يُقتل جميع أفراد الأسرة خلال الهجوم، ذلك أنّ معظم الهجمات تحصل خلال فترة الصباح الباكر بينما الناس نيام.
ولَكُم أن تتخيّلوا الآثارَ النفسيّة التي تصاحب الأطفال الناجين من هذه الاعتداءات جرّاء ما شاهدوه من قتلٍ لأهلهم أمام أعينهم، أو رؤيتهم مرميّين على الأرض. ومن المعروف أنّ المدن والقرى التي يقع فيها الاقتتال القبَليّ لا توجد فيها صفّارات إنذار لتحذير الأهالي من قرب الهجوم، ما يسبّب خسائر كبيرةً في الأرواح. ولا ننسى في هذا السياق بالطبع حالات الإجهاض بين الحوامل.
لقد أجبرت الحروب الأهليّة، والعرقيّة منها، على مدى أكثر من عقدين، العديدَ من سكّان السودان على الفرار إلى الدول المجاورة، لا سيّما إلى تشاد التي تتصدّر المرتبة الأولى لناحية استقبال اللاجئين. وقد بلغ عدد الفارّين إلى تشاد مليونَي نسمة في العام 2003. وبعد 15 نيسان/ أبريل 2023، أُجبر حوالي ثلاثة أرباع سكان السودان على الفرار إلى دول الجوار، وقد حصدت تشاد وحدها حوالي ثلاثة ملايين نسمة. ومع إضافة اللاجئين القدامى إليها نكون أمام عددٍ إجماليّ يبلغ حوالي خمسة ملايين لاجئ في تشاد.
تمكّنت «المفوّضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللّاجئين» من تسجيل حوالي مليون شخص جديد (والأرقام في تغيّر مستمرّ)، لكنّ أغلب اللّاجئين ما زالوا خارج اعتماد المفوّضية، لذلك نجد في كلّ قرية ومدينة داخل تشاد لاجئين غير مسجلّين في مستنداتها. ويرجع هذا الأمر إلى عوامل عدّة منها:
تحتلّ دولة جنوب السودان المرتبةَ الثانية لناحية استقبال اللّاجئين من السودان والذين يصل عددهم فيها إلى أكثر من أربعة ملايين، والأعداد إلى ارتفاع. ومن الصعب التدقيق في العدد الفعليّ لهؤلاء، لكنّ جنوب السودان في الواقع دولة مثقلة باللّاجئين على مستوى إفريقيا كلّها.
إفريقيا الوسطى هي الأخرى من الدول الأعلى استقبالًا للاجئي السودان. وعلى الرغم من وعورة طرقها وغاباتها الكثيفة التي تحمل مخاطر لا حصر لها، إلا أنّها تستضيف أعدادًا هائلة من اللّاجئين الذين يفوق عددهم مليون نسمة. من هؤلاء من يعيش داخل المخيّمات، وآخرون في الغابات التي تحوي قرى. وفي ظلّ هذه الظروف القاهرة، وبفعل العوامل البيئيّة والاقتصاديّة وغيرها، ترتفع نسبة الوفيّات بين الأطفال الصغار في السنّ هناك.
أمّا مصر، فبفعل تقدّم أنظمتها وعملها بنظام تأشيرات الدخول، يمكن إحصاء حوالي 900 ألف لاجئ فيها، مع الإشارة إلى أنّ هناك من دخلوا إليها بطريقة غير شرعيّة. ليبيا كذلك تحصد وحدها قرابة مليونَي لاجئ سوداني منتشرين في أرجائها. وهناك كذلك حوالي مليونَي لاجئ منتشرين في كلٍّ من النيجر ونيجيريا والكاميرون وأوغندا ومالي وبنين وغانا، وما لا يقلّ عن 800 ألف لاجئ في إثيوبيا. وهناك من اللاجئين من ركب البحر، حاملاً معه أطفاله، باتّجاه أوروبا، باتّجاه المجهول.